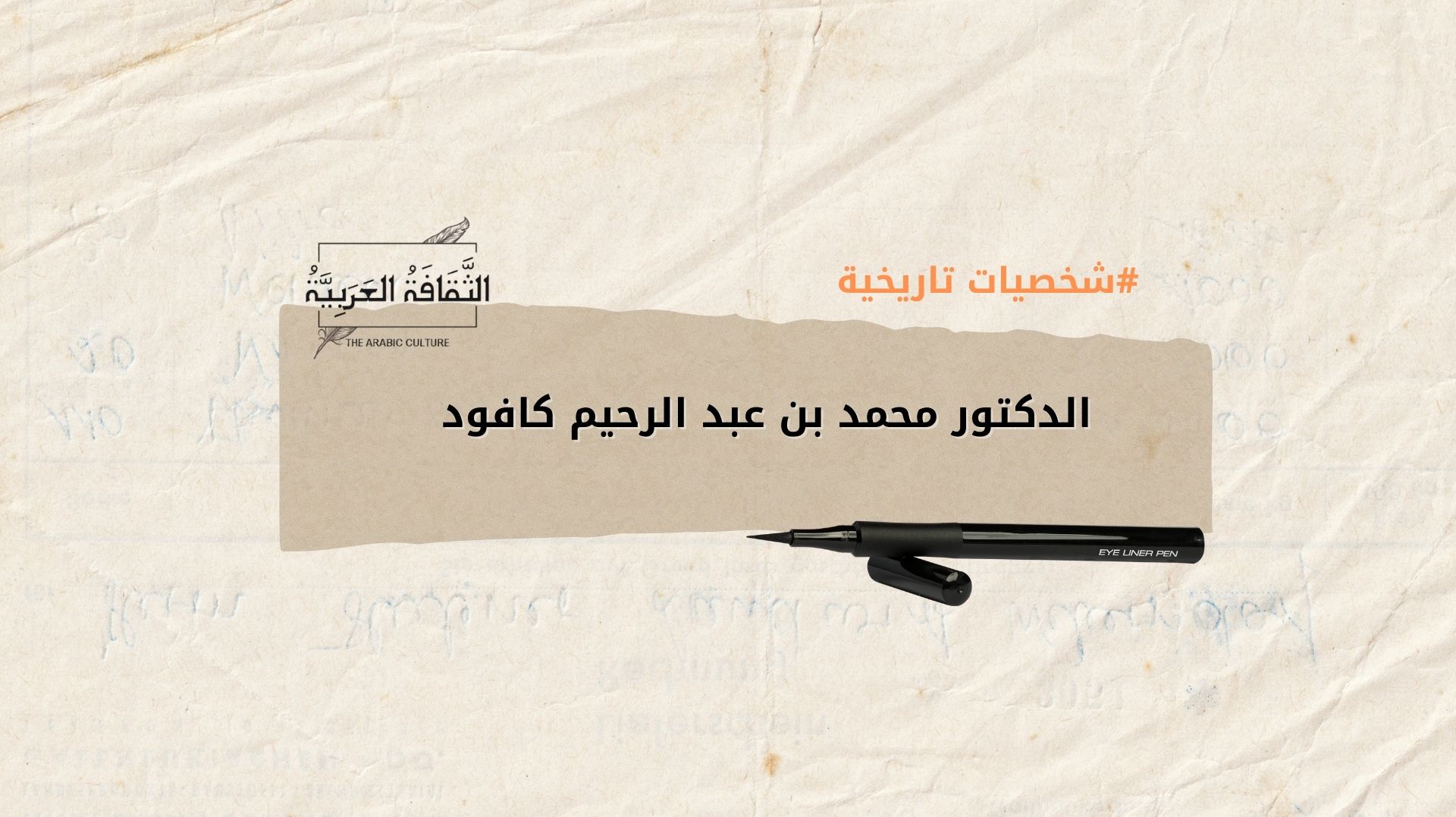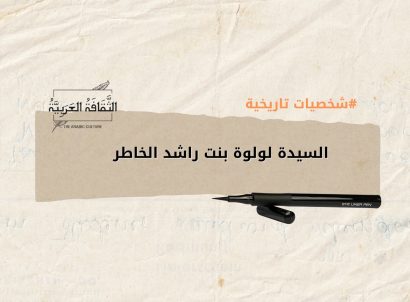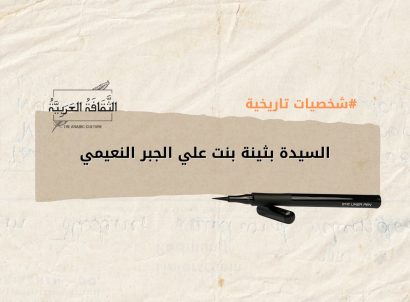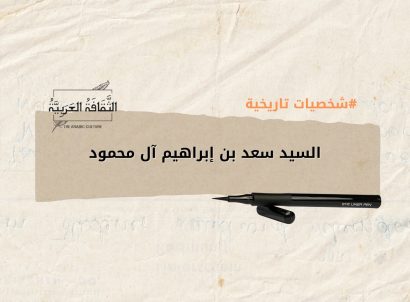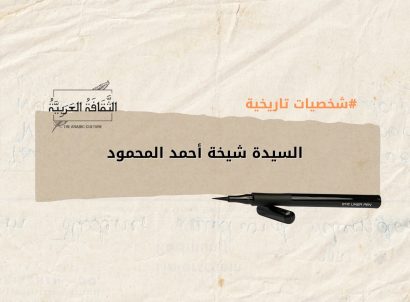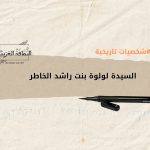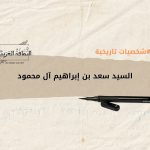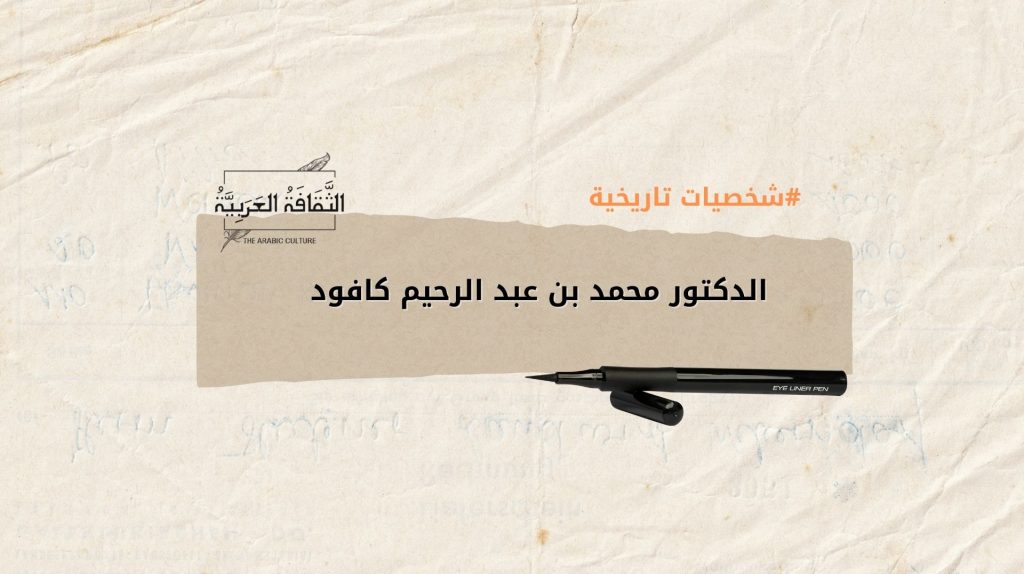
المعلومات الشخصية والتعليم
- الاسم: محمد بن عبد الرحيم بن أحمد كافود
- الميلاد: وُلد في منطقة مشيرب في الدوحة عام 1949. Alayam
- التعليم:
- بكالوريوس آداب (لغة عربية) – جامعة الأزهر، 1974. dohabookfair.qa
- ماجستير في الأدب الحديث (الأدب القطري الحديث) – جامعة الأزهر، 1978. dohabookfair.qa
- دكتوراه في النقد الحديث (النقد الأدبي الحديث في الخليج العربي) – جامعة الأزهر، 1981. dohabookfair.qa
المسيرة الأكاديمية
- بدأ حياته المهنية في جامعة قطر كمعيد في كلية التربية بعد عودته من الدراسة. alithnainya.com
- تدرّج عبر مناصب متعددة في الجامعة منها:
- مدرس، أستاذ مساعد، ثم أستاذ في قسم اللغة العربية. alithnainya.com
- عميد شؤون الطلاب ثم عميد كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية. alithnainya.com
- شغل منصب نائب مدير جامعة قطر للبحوث وخدمة المجتمع قبل الانتقال للعمل الحكومي. alithnainya.com
المناصب الحكومية
- وزير التربية والتعليم والثقافة في قطر ابتداءً من 30 أكتوبر 1996، بعد قرار أمير البلاد في ذلك الحين. Alayam
- حينها كان اسم الوزارة يجمع بين التربية والتعليم والثقافة، ومن أبرز مسؤولياته تحديث التعليم وتنظيمه ضمن رؤية وطنية. Alayam
- طالب بفصل الثقافة عن شؤون التعليم مما أدّى إلى تطور هيكلة الوزارة لاحقًا وتغيير المسمّى الوزاري. dohabookfair.qa
- شغل بعد ذلك منصب وزير التربية والتعليم والتعليم العالي (بعد إعادة تنظيم الوزارة). alithnainya.com
- كان رئيسًا لـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث بعد خروجه من الوزارة، وساهم في تعزيز نشاطات ثقافية وفنية على المستوى الوطني. alithnainya.com
الإسهامات العلمية والثقافية
- له عدة مؤلفات في الأدب والنقد، من أشهرها:
- الأدب القطري الحديث. dohabookfair.qa
- النقد الأدبي الحديث في الخليج العربي. dohabookfair.qa
- القصة القصيرة في قطر: النشأة والتطور. dohabookfair.qa
- دراسات في الشعر العربي المعاصر. dohabookfair.qa
- تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. dohabookfair.qa
- مكتبة شخصية ضخمة: جمع نحو 17,000 عنوانٍ من الكتب التي تجاوزت 30,000 نسخة، وتتنوع بين الأدب والعلوم الإنسانية. moc.gov.qa
الجوائز والعضويات
- عضو مجمع اللغة العربية المصري كمراسِل تقديرًا لإسهاماته الثقافية. dohabookfair.qa
- عضو في مجلس أمناء مؤسسة البابطين للشعر بالبحرين. dohabookfair.qa
- عضو في اللجنة الاستشارية لـ مؤسسة الفكر العربي. dohabookfair.qa
- نال «درع الضاد» من لجنة جائزة كتارا للرواية العربية تقديرًا لجهوده في نصرة اللغة العربية. Alarab
أبرز النقاط
- وزيرًا للتربية والتعليم والثقافة عام 1996، وهو منصب حكومي مهم في تطوير منظومة التعليم والثقافة في قطر آنذاك. صحيفة 14 أكتوبر
- عمل عبر مسيرة أكاديمية وحكومية طويلة تشمل التعليم الجامعي، الإدارة العليا، والقيادة الفكرية والثقافية في المجتمع القطري والعربي. alithnainya.com
- أثرى الساحة الثقافية بعدد من الكتب والدراسات المهمة في الأدب العربي والخليجي. dohabookfair.qa
مراجع المصادر:
- السيرة والمناصب الأكاديمية والعلمية من وثيقة سيرة ذاتية ومقالات ثقافية. dohabookfair.qa+1
- تاريخ تولّيه وزارة التربية والتعليم والثقافة. صحيفة 14 أكتوبر
- مقتطفات عن مكتبته ومساهماته الثقافية. moc.gov.qa
- جائزة «درع الضاد» ودفاعه عن العربية. Alarab