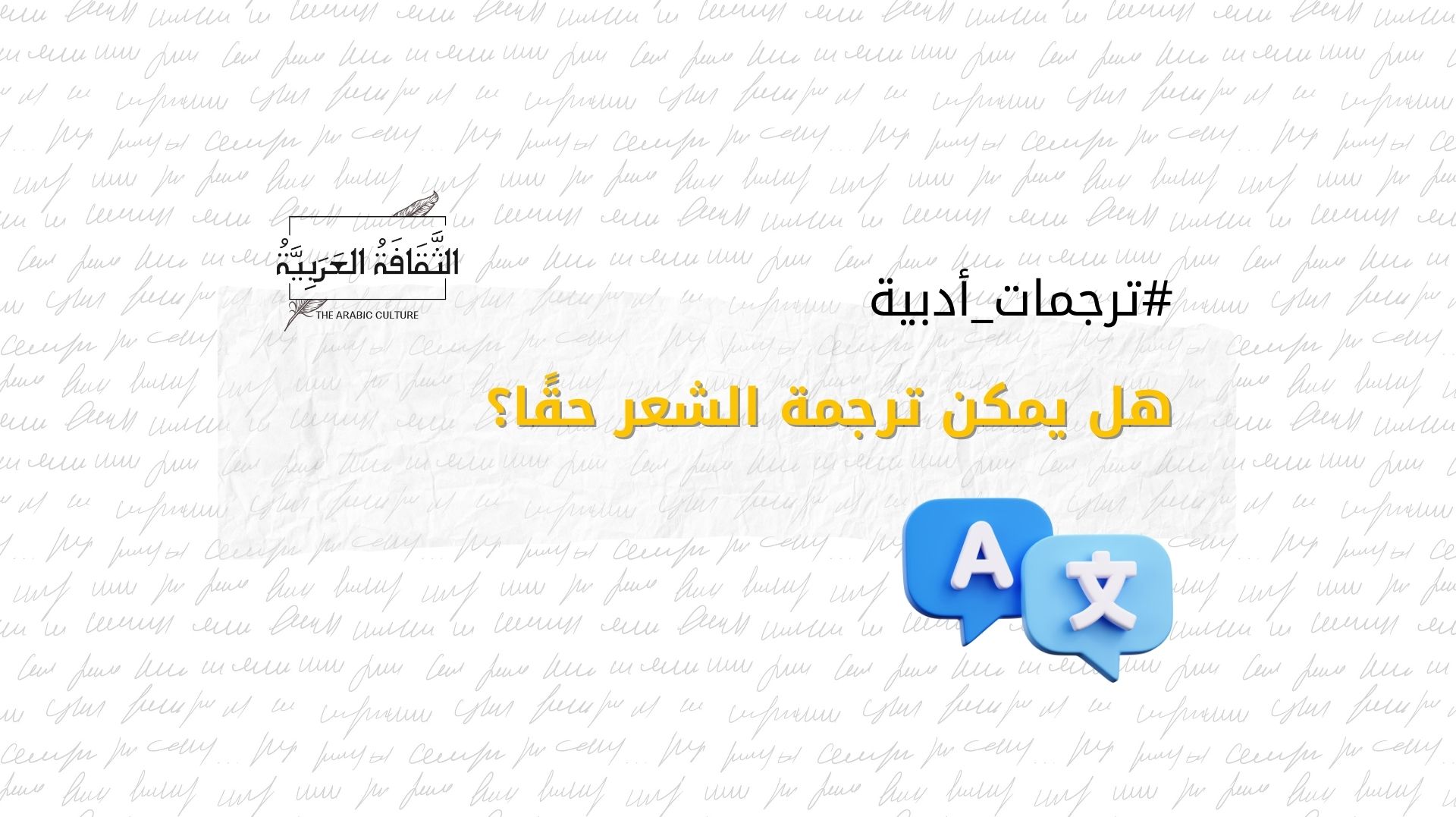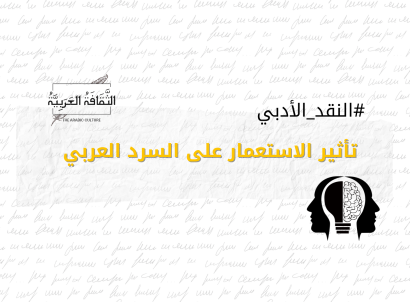الشعر هو اللغة في أقصى حالاتها.
هو توازن بين المعنى والموسيقى، بين الإيحاء والإيقاع.
وحين يُترجم، لا ينتقل كالكلمات العادية.
ينتقل كروح تبحث عن جسد جديد.
منذ قرون، اختلف النقاد حول إمكانية ترجمة الشعر.
الشاعر الروماني هوراس رأى أن الشعر يفقد سحره خارج لغته.
أما غوته فاعتبر الترجمة “امتحانًا لقدرة الشعر على العيش في لغة أخرى”.
الواقع يؤكد أن ترجمة الشعر ليست نقلاً بل خلقًا جديدًا.
المترجم لا يترجم وزنًا أو قافية فقط، بل شعورًا، إيقاعًا، إحساسًا بالزمن.
كل لغة تمتلك موسيقاها الداخلية.
ما يصلح بالعربية لا يُقال بالإنجليزية بنفس الرنين أو التوتر.
حين تُترجم قصيدة عربية إلى الفرنسية، أو من الروسية إلى الإسبانية، يحدث فقدٌ لا مفرّ منه.
لكن الفقد ليس دائمًا خسارة.
أحيانًا يكون تحوّلًا.
فالقصيدة المترجمة تعيش حياة ثانية، مختلفة، لكنها ما تزال تحمل قلب الأصل.
المترجم هنا يصبح شاعرًا ثانيًا.
يُعيد بناء الصورة بالكلمات المتاحة في لغته،
ويحاول أن يُبقي على نبض النص دون أن يختنق تحت وطأة الحرف.
الترجمة الحرفية تقتل الشعر.
والترجمة الحرة تخلق شعرًا آخر.
بينهما مساحة دقيقة يختبر فيها المترجم مهارته وذائقته ووعيه الثقافي.
مثال واضح على هذا نجده في ترجمات محمود درويش إلى الإنجليزية.
القارئ الأجنبي لا يسمع موسيقى العربية،
لكنه يلتقط المعنى الكوني، الإحساس بالغربة، والمجاز الإنساني.
هذه ليست خيانة، بل تأويل جديد لروح القصيدة.
لذلك لا يمكن القول إن الشعر يُترجم أو لا يُترجم.
بل يُعاد تجسيده في لغة أخرى.
كل ترجمة هي قراءة شعرية جديدة،
ومحاولة لإبقاء المعنى حيًا رغم اختلاف الأجساد.
المراجع:
- Robert Frost, “Poetry is what gets lost in translation.”
- Octavio Paz, The Art of Translation, 1971.
- John Dryden, Preface to Ovid’s Epistles, 1680.
- Ezra Pound, ABC of Reading, 1934.
- Susan Bassnett, Translation Studies, Routledge, 2014.