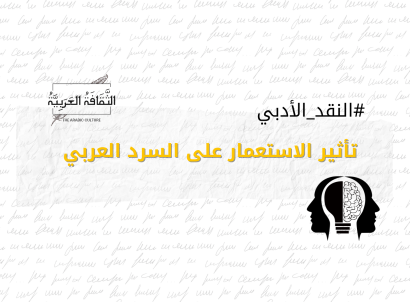اللغة هي الأداة الأولى في الأدب. لكنها ليست مجرد وسيلة للتعبير، بل كائن حي يربط الكاتب بالعالم. في الأدب الحديث، أصبحت اللغة موضوعاً بحد ذاتها، سلاحاً مزدوج الحدّ: يمكن أن تفتح الأبواب أو تغلقها.
اللغة كجسر
اللغة تربط الشعوب. تجعل الأدب ينتقل من ثقافة إلى أخرى. عندما تُترجم رواية، فإنها تبني جسراً بين حضارتين. القارئ يكتشف عوالم جديدة، يفهم كيف يفكر الآخر، كيف يحلم، كيف يعاني.
الأدب الحديث اعتمد على هذا الجسر. أعمال مثل “الخيميائي” لباولو كويلو أو “مئة عام من العزلة” لماركيز، وصلت إلى قراء من لغات وثقافات متعددة لأن الترجمة أعادت خلقها بلغة قريبة من القلوب.
حتى داخل اللغة الواحدة، تكون اللغة جسراً بين الكاتب والقارئ. الكاتب الذي يكتب بلغة صادقة وبسيطة يفتح الطريق للتواصل الحقيقي.
اللغة كحاجز
لكن اللغة قد تتحول إلى حاجز حين تنغلق على نفسها. حين يستخدم الكاتب لغة معقدة أو غامضة أو نخبوية، يصبح الأدب بعيداً عن الناس. القارئ يشعر أن النص يتحدث بلغة لا تخصه.
الترجمة أيضاً قد تكون حاجزاً عندما تفقد روح النص الأصلي أو تسقط في النقل الحرفي. هناك كلمات ومعانٍ لا يمكن نقلها بدقة، لأن كل لغة تحمل داخلها ثقافة كاملة.
في العالم العربي مثلاً، التباعد بين الفصحى والعامية خلق فجوة بين الأدب والجمهور. كثير من القراء يجدون صعوبة في فهم النصوص الأدبية المكتوبة بلغة فصحى عالية، بينما يرفض بعض النقاد اعتماد العامية باعتبارها تهديداً للهوية. النتيجة أن اللغة نفسها أصبحت ميدان صراع بين النخبة والجمهور.
الأدب الحديث ومهمة التوازن
الكاتب المعاصر يواجه تحدياً مزدوجاً: أن يكتب بلغة تعبّر عن روحه، وفي الوقت نفسه تصل إلى الآخرين. اللغة لا تكون جسراً إلا إذا كانت صادقة، حية، قادرة على التطور.
نجيب محفوظ مثلاً استخدم الفصحى في السرد، والعامية في الحوار، فحقق توازناً جعل رواياته قريبة من كل قارئ.
الكتّاب الشباب اليوم يواجهون نفس السؤال: هل يكتبون كما يتحدث الناس؟ أم كما يعلّمهم التراث؟
اللغة ليست حاجزاً أو جسراً في حد ذاتها. هي ما يجعلها الكاتب.
إذا كتب ليُفهم، صارت اللغة جسراً.
إذا كتب ليتباهى، صارت اللغة جداراً.
الأدب الحديث لا يبحث عن لغة جديدة، بل عن صدق جديد في اللغة.
حين تتحرر الكلمة من الزخرفة وتقترب من الإنسان، تتحول من حاجز إلى جسر، ومن أداة إلى حياة.